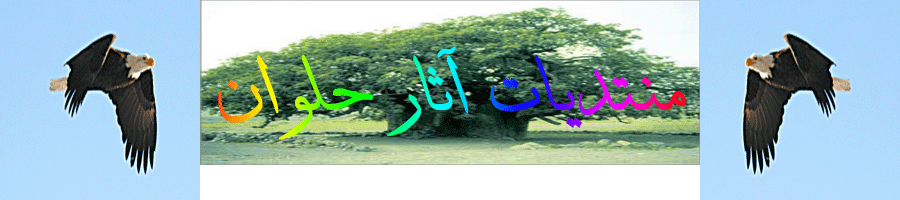Admin
Admin

عدد المساهمات : 371
تاريخ التسجيل : 23/06/2009
 |  موضوع: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1-3) موضوع: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1-3)  السبت نوفمبر 27, 2010 4:33 pm السبت نوفمبر 27, 2010 4:33 pm | |
| |
ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم، بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد، بل واقعة مرة بعد مرة وهي واضحة جدًا فيما ذكرنا، ويؤيّده أيضًا أن البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدلّ على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدة، وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث، وهو صريح في محل النزاع، مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى.
ففي " السنن الكبرى " للبيهقي ما نصه: قال الشيخ: ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترى، روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، قال عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا. وإذا كانت تترى فليس بشىء. قال سفيان الثوري تترى يعني أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فإنها تبين بالأولى، والثنتان ليستا بشىء، وروي عن عكرمة عن ابن عباس ما دلّ على ذلك، انتهى منه بلفظه. فهذه أدلة واضحة على أن الثلاث في حديث طاوس ليست بلفظ واحد، بل مسرودة بألفاظ متفرقة كما جزم به الإمام النسائي رحمه الله وصححه النووي والقرطبي وابن سريج وأبو يحيى الساجي، وذكره البيهقي عن الشعبي عن ابن عباس، وعن عكرمة عن ابن عباس، وتؤيده رواية أيوب التي صححها ابن القيم كما ذكره البيهقي وأوضحناه آنفًا مع أنه لا يوجد دليل يعين كون الثلاث المذكورة في حديث طاوس المذكور بلفظ واحد، لا من وضع اللغة، ولا من العرف، ولا من الشرع، ولا من العقل؛ لأن روايات حديث طاوس ليس في شىء منها التصريح بأن الثلاث المذكورة واقعة بلفظ واحد، ومجرد لفظ الثلاث، أو طلاق الثلاث، أو الطلاق الثلاث، لا يدل على أنها بلفظ واحد لصدق كل تلك العبارات على الثلاث الواقعة بألفاظ متفرّقة كما رأيت، ونحن لا نفرق في هذا بين البر والفاجر، ولا بين زمن وزمن، وإنما نفرق بين من نوى التأكيد، ومن نوى التأسيس،
والفرق بينهما لا يمكن إنكاره، ونقول الذي يظهر أن ما فعله عمر إنما هو لما علم من كثرة قصد التأسيس في زمنه، بعد أن كان في الزمن الذي قبله قصد التأكيد هو الأغلب كما قدمنا، وتغيير معنى اللفظ لتغير قصد اللافظين به لا إشكال فيه، فقوة هذا الوجه واتجاهه وجريانه على اللغة، مع عدم إشكال فيه كما ترى. وبالجملة بلفظ رواية أيوب التي أخرجها أبو داود.
وقال ابن القيم: إنها بأصح إسناد مطابق للفظ حديث عائشة الثابت في " الصحيحين "، الذي فيه التصريح من النبيّ صلى الله عليه وسلم بأنها لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الثاني كما ذاقها الأول. وبه تعرف أن جعل الثلاث في حديث عائشة متفرقة في أوقات متباينة، وجعلها في حديث طاوس بلفظ واحد تفريق لا وجه له مع اتحاد لفظ المتن في رواية أبي داود، ومع أن القائلين برد الثلاث المجتمعة إلى واحدة لا يجدون فرقًا في المعنى بين رواية أيوب وغيرها من روايات حديث طاوس.
ونحن نقول للقائلين برد الثلاث إلى واحدة إما أن يكون معنى الثلاث في حديث عائشة وحديث طاوس أنها مجتمعة أو مفرقة، فإن كانت مجتمعة فحديث عائشة متفق عليه فهو أولى بالتقديم، وفيه التصريح بأن تلك الثلاث تحرمها ولا تحل إلا بعد زوج، وإن كانت متفرقة فلا حجة لكم أصلاً في حديث طاوس على محل النزاع؛ لأن النزاع في خصوص الثلاث بلفظ واحد.
أما جعلكم الثلاث في حديث عائشة مفرقة، وفي حديث طاوس مجتمعة فلا وجه له ولا دليل عليه، ولا سيما أن بعض رواياته مطابق لفظه للفظ حديث عائشة، وأنتم لا ترون فرقًا بين معاني ألفاظ رواياته من جهة كون الثلاث مجتمعة لا متفرقة.
وأما على كون معنى حديث طاوس أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هي المجموعة بلفظ واحد فإنه على هذا يتعين النسخ كما جزم به أبو داود رحمه اللَّه، وجزم به ابن حجر في " فتح الباري "، وهو قول الشافعي كما قدمنا عنه، وقال به غير واحد من العلماء.
وقد رأيت النصوص الدالة على النسخ التي تفيد أن المراد بجعل الثلاث واحدة، أنه في الزمن الذي كان لا فرق فيه بين واحدة وثلاث، ولو متفرقة؛ لجواز الرجعة ولو بعد مائة تطليقة، متفرقة كانت أو لا. وأن المراد بمن كان يفعله في زمن أبي بكر هو من لم يبلغه النسخ، وفي زمن عمر اشتهر النسخ بين الجميع. وادعاء أن مثل هذا لا يصح يرده بإيضاح وقوع مثله في نكاح المتعة، فإنا قد قدمنا أن مسلمًا روى عن جابر أنها كانت تفعل على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وفي بعض من زمن عمر قال: فنهانا عنها عمر. وهذه الصورة هي التي وقعت في جعل الثلاث واحدة، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما، فادعاء إمكان إحداهما واستحالة الأخرى في غاية السقوط كما ترى؛ لأن كل واحدة منهما، روى فيها مسلم في " صحيحه " عن صحابي جليل، أن مسألة تتعلق بالفروج كانت تفعل في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، ثم غير حكمها عمر، والنسخ ثابت في كل واحدة منهما. وأما غير هذين الأمرين فلا ينبغي أن يقال؛ لأن نسبة عمر بن الخطاب ـ رضي اللَّه عنه ـ وعبد اللَّه بن عباس ـ رضي اللَّه عنهما ـ وخلق من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أنهم تركوا ما جاء به النبيّ صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بما يخالفه من تلقاء أنفسهم عمدًا غير لائق، ومعلوم أنه باطل بلا شك.
وقد حكى غير واحد من العلماء أن الصحابة أجمعوا في زمن عمر على نفوذ الطلاق الثلاث دفعة واحدة.
والظاهر أن مراد المدعي لهذا الإجماع هو الإجماع السكوتي، مع أن بعض العلماء ذكر الخلاف في ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقد قدمنا كلام أبي بكر بن العربي القائل: بأن نسبة ذلك إلى بعض الصحابة كذب بحت، وأنه لم يثبت عن أحد منهم جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، وما ذكره بعض أجلاء العلماء من أن عمر إنما أوقع عليهم الثلاث مجتمعة عقوبة لهم، مع أنه يعلم أن ذلك خلاف ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والمسلمون في زمن أبي بكر رضي اللَّه عنه فالظاهر عدم نهوضه؛ لأن عمر لا يسوغ له أن يحرم فرجًا أحلّه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلا يصح منه أن يعلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يبيح ذلك الفرج بجواز الرجعة ويتجرأ هو على منعه بالبينونة الكبرى، واللَّه تعالى يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} الآية ( 95/7 )، ويقول: {آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} ( 01/95 )، ويقول: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ( 24/12 ).
والمروي عن عمر في عقوبة من فعل ما لا يجوز من الطلاق هو التعزير الشرعي المعروف، كالضرب. أما تحريم المباح من الفروج فليس من أنواع التعزيزات؛ لأنه يفضي إلى حرمته على من أحله اللَّه له وإباحته لمن حرمه عليه؛ لأنه إن أكره على إبانتها وهي غير بائن في نفس الأمر لا تحل لغيره؛ لأن زوجها لم يبنها عن طيب نفس وحكم الحاكم وفتواه لا يحل الحرام في نفس الأمر،
ويدل له حديث أم سلمة المتفق عليه فإن فيه: "فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئًا، فكأنما أقطع له قطعة من نار" ويشير له قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً} ( 33/73 )؛ لأنه يفهم منه أنه لو لم يتركها اختيارًا لقضائه وطره منها ما حلت لغيره.
وقد قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ما نصه: وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر، إنها كانت تفعل في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك.
ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دلّ إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منا بذلة، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق، واللَّه أعلم. اهـ منه بلفظه.
 وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات: وحاصل خلاصة هذه المسألة أن البحث فيها من ثلاث جهات:
الأولى: من جهة دلالة النص القولي أو الفعلي الصريح.
الثانية: من جهة صناعة علم الحديث والأصول.
الثالثة: من جهة أقوال أهل العلم فيها أما أقوال أهل العلم فيها فلا يخفى أن الأئمة الأربعة وأتباعهم وجلّ الصحابة وأكثر العلماء على نفوذ الثلاث دفعة بلفظ واحد، وادعى غير واحد على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم.
وأما من جهة نص صريح من قول النبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعله فلم يثبت من لفظ النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا من فعله ما يدلّ على جعل الثلاث واحدة، وقد مر لك أن أثبت ما روي في قصة طلاق ركانة أنه بلفظ البتّة، وأن النبيّ حلّفه ما أراد إلا واحدة، ولو كان لا يلزم أكثر من واحدة بلفظ واحد لما كان لتحليفه معنى. وقد جاء في حديث ابن عمر عند الدارقطني أنه قال: يا رسول اللَّه، أرأيت لو طلقتها ثلاثًا أكان يحلّ لي أن أراجعها ؟ قال: "لا، كانت تبين منك، وتكون معصية".
وقد قدمنا أن في إسناده عطاء الخراساني، وشعيب بن زريق الشامي، وقد قدمنا أن عطاء المذذكور من رجال مسلم، وأن شعيبًا المذكور قال فيه ابن حجر في "التقريب": صدوق يخطىء، وأن حديث ابن عمر هذا يعتضد بما ثبت عن ابن عمر في "الصحيح" من أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك.
ولا سيما على قول الحاكم: إنه مرفوع ويعتضد بالحديث المذكور قبله؛ لتحليفه ركانة وبحديث الحسن بن علي المتقدم عند البيهقي والطبراني، وبحديث سهل بن سعد الساعدي الثابت في الصحيح، في لعان عويمر وزوجه، ولا سيّما رواية فأنفذها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاث المجتمعة وببقية الأحاديث المتقدمة.
وقد قدمنا أن كثرة طرقها واختلاف منازعها يدل على أن لها أصلاً وأن بعضها يشد بعضًا فيصلح المجموع للاحتجاج. ولا سيّما أن بعضها صححه بعض العلماء وحسنه بعضهم، كحديث ركانة المتقدم. وقد عرفت أن حديث داود بن الحصين لا دليل فيه على تقدير ثبوته، فإذا حققت أن المروى باللفظ الصريح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس يدلّ إلا على وقوع الثلاث مجتمعة، فاعلم أن كتاب اللَّه ليس فيه شىء يدلّ على عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة؛ لأنه ليس فيه آية ذكر الثلاث المجتمعة، وأحرى آية تصرح بعدم لزومها.
وقد قدمنا عن النووي وغيره أن العلماء استدلوا على وقوع الثلاث دفعة بقوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} ( 56/1 )، قالوا معناه: أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه؛ لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع، لم يقع طلاقه إلا رجعيًا، فلا يندم.
وقد قدمنا ما ثبت عن ابن عباس من أنها تلزم مجتمعة، وأن ذلك داخل في معنى الآية وهو واضح جدًا، فاتضح أنه ليس في كتاب اللَّه ولا في صريح قول النبيّ صلى الله عليه وسلم أو فعله ما يدل على عدم وقوع الثلاث.
أما من جهة صناعة علم الحديث، والأصول، فما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس المتقدم له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي كان يفعل كذا على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، له حكم الرفع عند جمهور المحدثين والأصوليين.
وقد علمت أوجه الجواب عنه بإيضاح. ورأيت الروايات المصرحة بنسخ المراجعة بعد "لثلاث"، وقد قدمنا أن جميع روايات حديث طاوس عن ابن عباس المذكور عند مسلم ليس في شىء منها التصريح بأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وقد قدمنا أيضًا أن بعض رواياته موافقة للفظ حديث عائشة الثابت في الصحيح. وأنه لا وجه للفرق بينهما، فإن حمل على أن الثلاث مجموعة فحديث عائشة أصح، وفيه التصريح بأن تلك المطلقة لا تحل إلا بعد زوج. وإن حمل على أنها بألفاظ متفرقة، فلا دليل إذن في حديث طاوس عن ابن عباس على محل النزاع، فإن قيل: أنتم تارة تقولون: إن حديث ابن عباس منسوخ، وتارة تقولون: ليس معناه أنها بلفظ واحد، بل بألفاظ متفرقة، فالجواب أن معنى كلامنا: أن الطلقات في حديث طاوس لا يتعين كونها بلفظ واحد، ولو فرضنا أنها بلفظ واحد، فجعلها واحدة منسوخ هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة. واللَّه تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.
{فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، لم يبين في هذه الآية ولا في غيرها من آيات الطلاق حكمة كون الطلاق بيد الرجل دون إذن المرأة، ولكنه بيّن في موضع آخر أن حكمة ذلك أن المرأة حقل تزرع فيه النطفة كما يزرع البذر في الأرض، ومن رأى أن حقله غير صالح للزراعة فالحكمة تقتضي أن لا يرغم على الازدراع فيه، وأن يترك وشأنه؛ ليختار حقلاً صالحًا لزراعته وذلك في قوله تعالى: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ}، كما تقدم إيضاحه.
{وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. صرح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شىء مما أعطى زوجته، إلا على سبيل الخلع، إذا خافا إلا يقيما حدود اللَّه، فيما بينهما، فلا جناح عليهما إذن في الخلع. أي: لا جناح عليها هي في الدفع، ولا عليه هو في الأخذ.
وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شىء مما أعطى الأزواج زوجاتهم، ولو كان المعطى قنطارًا وبين أن أخذه بهتان وإثم مبين، وبيّن أن السبب المانع من أخذ شىء منه هو أنه أفضى إليها بالجماع. وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً}.
وبيّن في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة؛ وذلك في قوله: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا}. وأشار إلى ذلك بقوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}.
تنبيــه
أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقًا؛ لأن اللَّه تعالى قال: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}، ثم ذكر الخلع بقوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}؛ لم يعتبره طلاقًا ثالثًا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ}.
وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر، وهو قول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد.
قال مقيده عفا اللَّه عنه الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي؛ لما تقدم مرفوعًا إليه صلى الله عليه وسلم من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وهو مرسل حسن.
قال في "فتح الباري": والأخذ بهذا الحديث أولى، فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح، قال: "إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين فلْيتق اللَّه في الثالثة، فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها، أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئًا".
وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألاَّ يُقيما حدودَ اللَّه؛ لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة. وقوله: {فَإِن طَلَّقَهَا} إنما كرره؛ ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة، الذي هو قوله: {فلا تحل له من بعد}. ولو فرعنا على أن قوله تعالى: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، يراد به عدم الرجعة، وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}، لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عدّ الخلع طلاقًا؛ لأن اللَّه تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج. فاستثنى منه صورة جائزة، ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا، كما هو ظاهر من سياق الآية.
وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا بائنًا مالك، وأبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وقد روي نحوه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيّب، والحسن، وعطعاء، وشريح، والشعبي، وإبراهيم، وجابر بن زيد، والثوري، والأوزاعي، وأبو عثمان البتي، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره.
غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين، أو أطلق فهو واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وللشافعي قول آخر في الخلع وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النيّة فليس هو بشىء بالكلية، قاله ابن كثير.
وممّا احتجّ به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين، عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه خالد بن أسيد، فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة، إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سمّيت.
قال الشافعي: ولا أعرف جهمان، وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثر، قاله ابن كثير والعلم عند اللَّه تعالى.
وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله وتكلّم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى، وأنه سَيِّىء الحفظ وروي مثله عن علي وضعفه ابن حزم، واللَّه تعالى أَعلم.
فروع الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق؛ وذلك لأنه تعالى عبّر بما الموصولة في قوله: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم؛ لأنها تعم كل ما تشمله صلاتها كما عقده في " مراقي السعود " بقوله: صيغه كل أو2(212) الجميع وقد تلا الذي التي الفروع
وهذا هو مذهب الجمهور، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: وقد اختلف العلماء رحمهم اللَّه في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها.
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
وقال ابن جرير: حدّثنا يعقوب بن إيراهيم، حدثنا ابن علية، أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة: أن عمر أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعاها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها، ورواه عبد الرزّاق عن معمر، عن أيوب، عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله، وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام.
وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمان، أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك ؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.
وقال عبد الرزّاق: أخبرنا معمر عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته قالت: كان لي زوج يقل على الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب. قالت: فكانت مني زلة يومًا، فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه، قال: نعم، قالت: ففعلت، قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي، فما دونه، أو قالت ما دون عقاص الرأس.
ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها، وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي.
وهذا مذهب مالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا يجوز الزيادة عليه. فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئًا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيِّب وعطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري، وطاوس، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والربيع بن أنس.
وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعي: القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد، وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، يعني: المختلعة، وحملوا معنى الآية على معنى: {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، أي: من الذي أعطاها؛ لتقدم قوله: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}،
أي: من ذلك وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه} منه، رواه ابن جرير، ولهذا قال بعده: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}. اهـ من ابن كثير بلفظه.
الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة: فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض، كعدة المطلقة منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق بن راهويه في الرواية المشهورة عنهما، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيِّب، وسليمان بن يسار، وعروة، وسالم، وأبو سلمة، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، والحسن، والشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبو عياض، وخلاس بن عمرو، وقتادة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو العبيد.
قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم، ومأخذهم في هذا: أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات، قاله ابن كثير.
قال مقيده عفا اللَّه عنه وكون الخلع طلاقًا ظاهر من جهة المعنى، لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج، وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا شرعًا إلا بالطلاق، فالعوض في مقابلته. ويدلّ له ما أخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس زوجه من حديث ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس، أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟" قالت: نعم، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" فإن قوله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج، وقول البخاري عقب سوقه للحديث المذكور.
قال أبو عبد اللَّه: لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يسقط الاحتجاج به؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرسله غيره ومراده بذلك: خصوص طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد اللَّه الطحان عن خالد، وهو الحذاء عن عكرمة مرسلاً، ثم برواية إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء مرسلاً، وعن أيوب موصولاً. ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة، وصلها الإسماعيلي، قاله الحافظ في " الفتح "، فظهر اعتضاد الطرق المرسلة بعضها ببضع، وبالطرق الموصولة.
وقوله في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها يظهر فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوض؛ بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة، والروايات بعضها يفسر بعضًا، كما هو معلوم في علوم الحديث.
وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقًا، وإنما يكون فسخًا فهو بعيد ولا دليل عليه. والكتاب والسنّةُ يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ. والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران:
أحدهما: ما ذكرنا آنفًا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء.
الثاني: أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة، ومما يوضح ذلك أن الإمام أحمد وهو، رحمه اللَّه تعالى ــ يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق، ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا: إن عدة المختلعة ثلاثة قروء كالمطلقة، فظهر عدم الملازمة عنده فإن قيل هذا الذي ذكرتم يدلّ على أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق كان طلاقًا، ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقًا، فالجواب: أن مرادنا بالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة": أن الطلاق المأمور به من قبله صلى الله عليه وسلم هو عوض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق. فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدلّ له الحديث المذكور دلالة واضحة.
وقال بعض العلماء: تعتدّ المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر، والربيع بنت معوذ، وعمها، وهو صحابي وأخرجه أصحاب السنن، والطبراني مرفوعًا والظاهر أن بعض أسانيده أقل درجاتها القبول، وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام. ولو خالف أكثر أهل العلم وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخًا، وبين الاعتداد بحيضة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر، وما وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل. وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضًا؛ لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة،بل الغرض الأعظم منها: الاحتياط لماء المطلق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات، أن الرحم لم يشتمل على حمل منه. ودلالة ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة، ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إجماعًا.
فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة، وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جعل حكمه واحدًا، فجوابه أنه لم يجعل واحدًا إلا لأن الحكمة فيه واحدة. ومما يوضح ذلك أن المطلق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته إجماعًا، بنصّ قوله تعالى: {مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، مع أنه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلق بعد الدخول، فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة، لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول.
ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلق؛ صيانة للأنساب، كان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً؛ لأن الرحم لم يعلق بها شىء من ماء المطلق حتى تطلب براءتها منه بالعدة، كما هو واضح. فإن قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة؟ قلنا: إن كان ثابتًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوض، وبين غيره في قدر العدة، ولا إشكال في ذلك. كما فرق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة. وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجب فيه عدة أصلاً. مع أن الكل فراق قبل الدخول. والفرق بين الفراق بعوض، والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة، فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني.
الفرع الثالث: اختلف العلماء في المخالعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال:
الأول: لا يلحقها طلاقه، لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع، وبهذا قول ابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، وجابر بن زيد، والحسن البصري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور كما نقله عنهم ابن كثير.
الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع، وإن سكت بينهما لم يقع، وهذا مذهب مالك.
|
| |
|